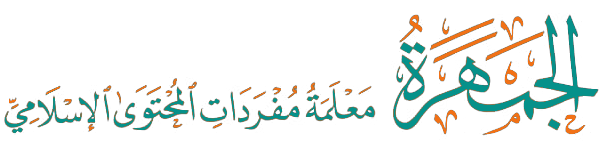العالم
كلمة (عالم) في اللغة اسم فاعل من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: «أُنْزِلَت آيَةُ المُتْعَةِ في كتاب اللَّه -تعالى-، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَم يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهَا، وَلَم يَنْهَ عَنهَا حَتَّى مات، قال رجل بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ»، قال البخاري: «يقال إنه عمر». وفي رواية: «نَزَلَت آيَةُ المُتْعَةِ -يَعْنِي مُتْعَةَ الحَجِّ- وَأَمَرَنا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ لَم تَنْزِل آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى مَاتَ». ولهما بمعناه.
[صحيح.] - [الرواية الأولى: متفق عليها. الرواية الثانية: رواها مسلم.]
ذكر عمران بن حصين رضي الله عنهما المتعة بالعمرة إلى الحج، فقال: إنها شرعت بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فأما الكتاب، فقوله -تعالى-: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾. وأما السنة: ففعل النبي ﷺ لها، وإقراره عليها، ولم ينزل قرآن يحرمها، ولم ينه عنها رسول الله ﷺ، وتوفي النبي ﷺ، وهي باقية لم تنسخ بعد هذا، فكيف يقول رجل برأيه وينهى عنها؟ يشير بذلك إلى نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنها في أشهر الحج؛ اجتهادا منه ليكثر زوار البيت في جميع العام؛ لأنهم إذا جاءوا بها مع الحج، لم يعودوا إليه في غير موسم الحج، وليس نهي عمر رضي الله عنه للتحريم أو لترك العمل بالكتاب والسنة، وإنما هو منع مؤقت للمصلحة العامة.
| آيَةُ المُتعَة | هي قوله -تعالى-: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}، [البقرة: 196] الآية. |
| في كِتَاب اللَّهِ -تعالى- | القرآن؛ وسمي بذلك: لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وأضيف إلى الله -عز وجل-؛ لأنه كلامه. |
| فَفَعَلنَاهَا | المتعة، والغرض من هذه الجملة: توكيد ثبوت مشروعيتها حيث طبقت فعلاً. |
| مع رسول الله | في صحبته ومعيته. |
| يُحَرِّمُهَا | يمنع منها. |
| لَم يَنهَ | أي: النبي -صلى الله عليه وسلم-، والنهي: طلب الكف. |
| عنها | عن المتعة. |
| رَجُلٌ | أخفاه كراهية لذكر اسمه في هذا المقام. |
| برَأيِهِ | بنظره المجرد عن الدليل. |
| ما شاء | ما أراد من القول، وهو المنهي عنها. |
| يقال | في تعيين الرجل المخفي في الحديث، وقائل ذلك: عمران بن حصين، كما في لفظ مسلم. |
| مُتعَة الحج | أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويحل منها، ثم يحرم بالحج من عامه. |
| تَنْسَخُ | ترفع الحكم. |
رمضانُ شهرُ الانتصاراتِ الإسلاميةِ العظيمةِ، والفتوحاتِ الخالدةِ في قديمِ التاريخِ وحديثِهِ.
ومنْ أعظمِ تلكَ الفتوحاتِ: فتحُ مكةَ، وكان في العشرينَ من شهرِ رمضانَ في العامِ الثامنِ منَ الهجرةِ المُشَرّفةِ.
فِي هذهِ الغزوةِ دخلَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ مكةَ في جيشٍ قِوامُه عشرةُ آلافِ مقاتلٍ، على إثْرِ نقضِ قريشٍ للعهدِ الذي أُبرمَ بينها وبينَهُ في صُلحِ الحُدَيْبِيَةِ، وبعدَ دخولِهِ مكةَ أخذَ صلىَ اللهُ عليهِ وسلمَ يطوفُ بالكعبةِ المُشرفةِ، ويَطعنُ الأصنامَ التي كانتْ حولَها بقَوسٍ في يدِهِ، وهوَ يُرددُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» (81)الإسراء، وأمرَ بتلكَ الأصنامِ فكُسِرَتْ، ولما رأى الرسولُ صناديدَ قريشٍ وقدْ طأطأوا رؤوسَهمْ ذُلاً وانكساراً سألهُم " ما تظنونَ أني فاعلٌ بكُم؟" قالوا: "خيراً، أخٌ كريمٌ وابنُ أخٍ كريمٍ"، فأعلنَ جوهرَ الرسالةِ المحمديةِ، رسالةِ الرأفةِ والرحمةِ، والعفوِ عندَ المَقدُرَةِ، بقولِه:" اليومَ أقولُ لكمْ ما قالَ أخِي يوسفُ من قبلُ: "لا تثريبَ عليكمْ اليومَ يغفرُ اللهُ لكمْ، وهو أرحمُ الراحمينْ، اذهبوا فأنتمُ الطُلَقَاءُ".